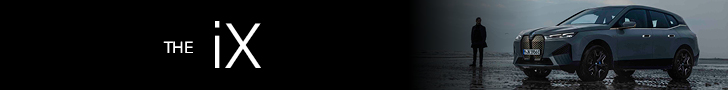دروس وعبر من سورة الأنفال

نزلت سورة أنفال في أعقاب غزوة بدر الكبرى، والتي تعتبر فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام،
ولهذا السبب أطلق عليها بعض الصحابة سورة بدر؛ لأنها تناولت أحداث هذه الغزوة بصورة مفصلة،
وفي هذا المقال سوف نوضح لكم دروس وعبر من سورة الأنفال.. تابعونا
دروس وعبر من سورة الأنفال
- تعد سورة الأنفال من السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع،
وخاصة ما يتعلق منه بالغزوات والجهاد في سبيل الله. - حيث تضمنت الآيات العديد من التشريعات الحربية والتوجيهات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها.
- كما تناولت جانب السلم والحرب وأحكام الأسرى والغنائم.
تفسير سورة الأنفال تحليلي
تفسير السعدي
” يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين “
الأنفال, هي: الغنائم, التي ينفلها اللّه لهذه الأمة, من أموال الكفار.
وكانت هذه الآيات في هذه السورة, قد نزلت في قصة ” بدر ” أول غنيمة كبيرة غنمها المسلون من المشركين.
فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع.
فسألوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عنها, فأنزل اللّه ” يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ” كيف تقسم وعلى من تقسم؟ ” قُلْ ” لهم ” الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ” يضعانها حيث شاءا, فلا اعتراض لكم على حكم اللّه ورسوله.
بل عليكم إذا حكم اللّه ورسوله, أن ترضوا بحكمهما, وتسلموا الأمر لهما.
وذلك داخل في قوله ” فَاتَّقُوا اللَّهَ ” بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه.
” وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ” أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن, والتقاطع, والتدابر, بالتوادد, والتحاب, والتواصل.
فبذلك تجتمع كلمتكم, ويزول ما يحصل – بسبب التقاطع – من التخاصم, والتشاجر والتنازع.
ويدخل في إصلاح ذات البين, تحسين الخلق لهم, والعفو عن المسيئين منهم فإنه – بذلك – يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء, والتدابر.
والأمر الجامع لذلك كله قوله ” وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ” .
فإن الإيمان يدعو إلى طاعة اللّه ورسوله.
كما أن من لم يطع اللّه ورسوله, فليس بمؤمن.
ومن نقصت طاعته للّه ورسوله, فذلك لنقص إيمانه.
” إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون “
ولما كان الإيمان قسمين, إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء, والفوز التام, وإيمانا,
دون ذلك – ذكر الإيمان الكامل فقال: ” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ” الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان.
” الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ” أي: خافت ورهبت, فأوجبت لهم, خشية اللّه تعالى, الانكفاف عن المحارم, ف
إن خوف اللّه تعالى, أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب.
” وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ” .
ووجه ذلك, أنهم يلقون له السمع, ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك, يزيد إيمانهم.
لأن التدبر من أعمال القلوب, ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى, كانوا يجهلونه, ويتذكرون ما كانوا نسوه.
أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير, واشتياقا إلى كرامة ربهم.
أو وجلا من العقوبات, وازدجارا عن المعاصي, وكل هذا مما يزداد به الإيمان.
” وَعَلَى رَبِّهِمْ ” وحده, لا شريك له ” يَتَوَكَّلُونَ ” أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم, في جلب مصالحهم, ودفع مضارهم الدينية, والدنيوية, ويثقون بأن اللّه تعالى, سيفعل ذلك.
والتوكل, هو, الحامل للأعمال كلها, فلا توجد ولا تكمل, إلا به.
” الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون “
” الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ” من فرائض, ونوافل, بأعمالها الظاهرة والباطنة, كحضور القلب فيها, الذي هو روح الصلاة ولبها.
” وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ” النفقات الواجبة, كالزكوات, والكفارات, والنفقة على الزوجات والأقارب, وما ملكت أيمانهم.
والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير.
” أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم “
” أُولَئِكَ ” الذين اتصفوا بتلك الصفات ” هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ” لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان, بين الأعمال الباطنة, والأعمال الظاهرة, بين العلم والعمل, بين أداء حقوق اللّه, وحقوق عباده.
وقدم تعالى أعمال القلوب, لأنها أصل لأعمال الجوارح, وأفضل منها.
وفيها دليل على أن الإيمان, يزيد وينقص, فيزيد بفعل الطاعة, وينقص بضدها.
وأنه ينبغي للعبد, أن يتعاهد إيمانه وينميه.
وأن أولى ما يحصل به ذلك, تدبر كتاب اللّه تعالى, والتأمل لمعانيه.
ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال: ” لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ” أي: عالية بحسب علو أعمالهم.
” وَمَغْفِرَةٌ ” لذنوبهم ” وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ” وهو ما أعد اللّه لهم في دار كرامته, مما لا عين رأت: ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر.
ودل هذا, على أن من يصل إلى درجتهم في الإيمان – وإن دخل الجنة – فلن ينال ما نالوا, من كرامة اللّه التامة.
” كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون “
قدم تعالى – أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة – الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها,
لأن من قام بها, استقامت أحواله, وصلحت أعماله, التي من أكبرها, الجهاد في سبيله.
فكما أن إيمانهم, هو الإيمان الحقيقي, وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم اللّه به.
كذلك أخرج اللّه رسوله صلى الله عليه وسلم, من بيته إلى لقاء المشركين في ” بدر ”
بالحق الذي يحبه اللّه تعالى, وقد قدره وقضاه.
وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج, أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال.
فحين تبين لهم أن ذلك واقع, جعل فريق من المؤمنين, يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم,
في ذلك, ويكرهون لقاء عدوهم, كأنما يساقون إلى الموت, وهم ينظرون.
والحال أن هذا, لا ينبغي منهم, خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق, ومما أمر اللّه به, ورضيه.
فهذه الحال, ليس للجدال فيها محل, لأن الجدال, محله وفائدته, عند اشتباه الحق, والتباس الأمر.
فأما إذا وضح وبان, فليس إلا الانقياد والإذعان.
هذا, وكثير من المؤمنين, لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء, ولا كرهوا لقاء عدوهم.
وكذلك الذين عاتبهم اللّه, انقادوا للجهاد أشد الانقياد, وثبتهم اللّه, وقيض لهم من الأسباب,
ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها.
وكان أصل خروجهم ليتعرضوا لعير, خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام, قافلة كبيرة.
فلما سمعوا برجوعها من الشام, ندب النبي صلى الله عليه وسلم, الناس.
فخرج معه, ثلثمائة, وبضعة عشر رجلا, معهم سبعون بعيرا, يعتقبون عليها, ويحملون عليها متاعهم.
فسمع بخبرهم قريش, فخرجوا لمنع عيرهم, في عدد كثير وعُدَدٍ وافرة, من السلاح, والخيل, والرجال, يبلغ عددهم قريبا من الألف.
” وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين “
فوعد اللّه المؤمنين, إحدى الطائفتين, إما أن يظفروا بالعير, أو بالنفير.
فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين, ولأنها غير ذات الشوكة.
ولكن اللّه تعالى, أحب لهم, وأراد أمرا, أعلى مما أحبوا.
أراد أن يظفروا بالنفير, الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم.
” وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ” فينصر أهله ” وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ” .
أي يستأصل أهل الباطل, ويُرِيَ عباده من نصرة للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم.
” ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون “
” لِيُحِقَّ الْحَقَّ ” بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه.
” وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ ” بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه ” وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ” فلا يبالي اللّه بهم.
” إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين “
أي: اذكروا نعمة اللّه عليكم, لما قارب التقاؤكم بعدوكم, استغثتم بربكم,
وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم ” فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ” وأغاثكم بعدة أمور.
منها أن اللّه أمدكم ” بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ” أي: يردف بعضهم بعضا.
” وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم “
” وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ ” أي إنزال الملائكة ” إِلَّا بُشْرَى ” أي: لتستبشر بذلك نفوسكم.
” وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ” وإلا فالنصر بيد اللّه, ليس بكثرة عدد, ولا عُدَدٍ.
” إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ” لا يغالبه مغالب, بل هو القهار, الذي يخذل من بلغوا من الكثرة, ومن العدد والآلات, ما بلغوا.
” حَكِيمٌ ” حيث قدر الأمور بأسبابها, ووضع الأشياء مواضعها.
” إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام “
ومن نصره واستجابته لدعائكم, أن أنزل عليكم نعاسا ” يُغَشِّيكُمُ ”
أي: فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل, ويكون ” أَمَنَةً ” لكم, وعلامة على النصر والطمأنينة.
ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرا, ليطهركم به من الحدث والخبث, وليطهركم من وساوس الشيطان, ورجزه.
” وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ” أي: يثبتها فإن ثبات القلب, أصل ثبات البدن.
” وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ” فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر, تلبدت, وثبتت به الأقدام.
” إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان “
ومن ذلك أن اللّه أوحى إلى الملائكة ” أَنِّي مَعَكُمْ ” بالعون والنصر والتأييد.
” فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ” أي: ألقوا في قلوبهم, وألهموم الجراءة على عدوهم, ورغبوهم في الجهاد وفضله.
” سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ” الذي هو أعظم جند لكم عليهم.
فإن اللّه إذا ثبت المؤمنين, وألقى الرعب في قلوب الكافرين, لم يقدر الكافرون على الثبات لهم, ومنحهم اللّه أكتافهم.
” فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ” أي: على الرقاب ” وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ” .
أي: مفصل.
وهذا خطاب, إما للملائكة الذين أوحى إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا, فيكون في ذلك دليل, أنهم باشروا القتال يوم بدر.
أو للمؤمنين يشجعهم اللّه, ويعلمهم كيف يقتلون المشركين, وأنهم لا يرحمونهم.
” ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب “
” ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ” أي: حاربوهما, وبارزوهما بالعداوة.
” وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ” ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه, وتقتيلهم.
” ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار “
” ذَلِكُمْ ” العذاب المذكور ” فَذُوقُوهُ ” أيها المشاققون للّه ورسوله عذابا معجلا.
” وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ” .
وفي هذه القصة من آيات اللّه العظيمة, ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, رسول اللّه حقا.
منها: أن اللّه وعدهم وعدا, فأنجزهموه.
ومنها: ما قال اللّه تعالى ” قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ” الآية.
ومنها: إجابة دعوة اللّه للمؤمنين, لما استغاثوه, بما ذكره من الأسباب.
وفيها الاعتناء العظيم, بحال عباده المؤمنين, وتقييض الأسباب, التي بها ثبت إيمانهم, ثبتت أقدامهم, وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية.
ومنها: أن من لطف اللّه بعبده, أن يسهل عليه طاعته, وييسرها بأسباب داخلية وخارجية.
” يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار “
أمر اللّه تعالى عباده المؤمنين, بالشجاعة الإيمانية, والقوة في أمره, والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان.
ونهاهم عن الفرار, إذا التقى الزحفان فقال: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ”
أي: صف القتال, وتزاحف الرجال, واقتراب بعضهم من بعض.
” فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ” , بل اثبتوا لقتالهم, واصبروا على جلادهم, فإن في ذلك, نصرة لدين اللّه,
وقوة لقلوب المؤمنين, وإرهابا للكافرين.
” ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير “
” وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ ”
أي: رجع ” بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ ” أي مقره ” جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ” .
وهذا يدل على أن الفرار من الزحف, من غير عذر, من أكبر الكبائر,
كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد.
ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال, وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى, ليكون أمكن له في القتال,
وأنكى لعدوه, فإنه لا بأس بذلك, لأنه لم يول دبره فارا, وإنما ولى دبره, ليستعلى على عدوه,
أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته, أو ليخدعه بذلك, أو غير ذلك من مقاصد المحاربين,
وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار, فإن ذلك جائز.
فإن كانت الفئة في العسكر, فالأمر في هذا واضح.
وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين
أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين, فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز.
ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون, أن الانهزام أحمد عاقبة, وأبقى عليهم.
أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم, فيبعد – في هذه الحال – أن تكون من الأحوال المرخص فيها,
لأنه – على هذا – لا يتصور الفرار المنهي عنه.
وهذه الآية مطلقة, وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد.
” فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم “
يقول تعالى – لما انهزم المشركون يوم بدر, وقتلهم المسلمون.
” فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ” بحولكم وقوتكم ” وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ” حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره.
” وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ” .
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم, وقت القتال, دخل العريش, وجعل يدعو اللّه, ويناشده في نصرته.
ثم خرج منه, فأخذ حفنة من تراب, فرماها في وجوه المشركين, فأوصلها اللّه إلى وجوههم.
فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه, وفمه, وعينيه منها.
فحينئذ انكسر حدهم, وفتر زندهم, وبان فيهم الفشل والضعف, فانهزموا.
يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك – حين رميت التراب – أوصلته إلى أعينهم, وإنما أوصلناه إليهم, بقوتنا واقتدارنا.
” وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ” أي: إن اللّه تعالى, قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين, من دون مباشرة قتال.
ولكن اللّه أراد أن يمتحن المؤمنين, ويوصلهم بالجهاد, إلى أعلى الدرجات, وأرفع المقامات, ويعطيهم أجرا حسنا, وثوابا جزيلا.
” إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ” يسمع تعالى, ما أسر به العبد, وما أعلن, ويعلم ما في قلبه, من النيات الصالحة وضدها.
فيقدر على العباد أقدارا, موافقة لعلمه وحكمته, ومصلحة عباده, ويجزي كلا بحسب نيته وعمله.
” ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين “
” ذَلِكُمْ ” النصر, من اللّه لكم ” وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ” أي: مضعف كل مكر وكيد,
يكيدون به الإسلام وأهله, وجاعل مكرهم محيقا بهم.
” إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد
ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين “
” إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ” أيها المشركون, أي: تطلبون من اللّه أن يوقع بأسه وعذابه.
على المعتدين الظالمين.
” فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ” حين أوقع اللّه بكم من عقابه, ما كان نكالا لكم, وعبرة للمتقين ” وَإِنْ تَنْتَهُوا ”
عن الاستفتاح ” فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ” لأنه ربما أمهلكم, ولم يعجل لكم النقمة.
” وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ ” أي: أعوانكم وأنصاركم, الذين تحاربون وتقاتلون,
معتمدين عليهم ” شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ” ومن كان اللّه معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده.
وهذه المعية التي أخبر اللّه أنه يؤيد بها المؤمنين, تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان.
فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات, فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه,
وإلا فلو قاموا بما أمر اللّه به من كل وجه.
لما انهزمت لهم راية انهزاما مستقرا ولا أديل عليهم عدوهم أبدا.
” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون “
لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين, أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته فقال:
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ” بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما.
” وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ ” أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة اللّه, وطاعة رسوله.
” وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ” ما يتلى عليكم من كتاب اللّه, وأوامره, ووصاياه, ونصائحه.
فتوليكم, في هذه الحال, من أقبح الأحوال.
” ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون “
” وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ” أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية,
التي لا حقيقة لها, فإنها حالة, لا يرضاها اللّه ولا رسوله.
فليس الإيمان بالتمني والتحلي, ولكنه ما وقر في القلوب, وصدقته الأعمال.
” إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون “
يقول تعالى: ” إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ” من لم تفد فيهم الآيات والنذر.
وهم ” الصُّمُّ ” عن استماع الحق ” الْبُكْمُ ” عن النطق به.
” الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ” ما ينفعهم, ويؤثرونه على ما يضرهم.
فهؤلاء, شر عند اللّه, من شرار الدواب, لأن اللّه أعطاهم, أسماعا وأبصارا, وأفئدة, ليستعملوها في طاعة اللّه,
فاستعملوها في معاصيه, وعدموا – بذلك – الخير الكثير.
فإنهم كانوا, بصدد أن يكونوا من خيار البرية, فأبوا هذا الطريق, واختاروا لأنفسهم, أن يكونوا من شر البرية.
والسمع الذين نفاه اللّه عنهم, سمع المعنى المؤثر في القلب.
وأما سمع الحجة, فقد قامت حجة اللّه تعالى عليهم, بما سمعوه من آياته.
وإنما لم يسمعهم السماع النافع, لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته.
” ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون “
” وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ” على الفرض والتقدير ” لَتَوَلَّوْا ” عن الطاعة ”
وَهُمْ مُعْرِضُونَ ” لا التفات لهم إلى الحق, بوجه من الوجوه.
وهذا دليل على أن اللّه تعالى, لا يمنع الإيمان والخير, إلا عمن لا خير فيه,
والذي لا يزكو لديه, ولا يثمر عنده.
وله الحمد تعالى والحكمة, في هذا.
” يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون “
يأمر تعالى, عباده المؤمنين, بما يقتضيه الإيمان منهم, وهو: الاستجابة للّه وللرسول,
أي: الانقياد لما أمر به, والمبادرة إلى ذلك, والدعوة إليه, والاجتناب لما نهيا عنه, والانكفاف عنه, والنهي عنه.
وقوله ” إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ” وصف ملازم, لكل ما دعا اللّه ورسوله إليه, وبيان لفائدته وحكمته,
فإن حياة القلب والروح, بعبودية اللّه تعالى, ولزوم طاعته, وطاعة رسوله, على الدوام.
ثم حذر عن عدم الاستجابة للّه وللرسول فقال: ” وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ”
فإياكم أن تردوا أمر اللّه, أول ما يأتيكم, فيحال بينكم وبينه, إذا أردتموه بعد ذلك,
وتختلف قلوبكم فإن اللّه يحول بين المرء وقلبه, يقلب القلوب حيث شاء, ويصرفها, أنى شاء.
فليكثر العبد من قول ” يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ” يا مصرف القلوب, اصرف قلبي إلى طاعتك.
” وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ” أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه, فيجازي المحسن بإحسانه, والمسيء بعصيانه.
” واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب “
” وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ” بل تصيب فاعل الظلم وغيره.
وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير, فإن عقوبته, تعم الفاعل وغيره.
وتُتَّقَى هذه الفتنة, بالنهي عن المنكر, وقمع أهل الشر والفساد, وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم, مهما أمكن.
” وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ” لمن تعرض لمساخطه, وجانب رضاه.
” واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس
فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون “
يقول تعالى – ممتنا على عباده, في نصرهم بعد الذلة, وتكثيرهم بعد القله, وإغنائهم بعد العيلة.
” وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ” أي: مقهورون تحت حكم غيركم ” تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ”
أي: يأخذوكم.
” فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ” فجعل لكم بلدا تأوون إليه,
وانتصر من أعدائكم على أيديكم, وغنمتم من أموالهم, ما كنتم به أغنياء.
” لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ” اللّه على منته العظيمة, وإحسانه التام, بأن تعبدوه, ولا تشركوا به شيئا.
” يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون “
يأمر تعالى, عباده المؤمنين, أن يؤدوا ما ائتمنهم اللّه عليه, من أوامره, ونواهيه.
فإن الأمانة قد عرضها اللّه على السماوات والأرض والجبال, فأبين أن يحملنها وأشفقن منها,
وحملها الإنسان, إنه كان ظلوما جهولا.
فمن أدى الأمانة, استحق من اللّه الثواب الجزيل, ومن لم يؤدها بل خانها, استحق العقاب الوبيل,
وصار خائنا للّه وللرسول ولأمانته, منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات, وأقبح الشيات,
وهي الخيانة, مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها, وهي: الأمانة.
” واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم “
ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده, فربما حملته محبته ذلك, على تقديم هوى نفسه,
على أداء أمانته, أخبر اللّه تعالى أن الأموال والأولاد, فتنة يبتلى اللّه بهما عبادة, وأنهما عارية,
ستؤدى لمن أعطاها, وترد لمن استودعها ” وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ” .
فإن كان لكم عقل ورَأْيٌ, فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة.
فالعاقل يوازن بين الأشياء, ويؤثر أولاها بالإيثار, وأحقها بالتقديم.
” يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم “
امتثال العبد لتقوى ربه, عنوان السعادة, وعلامة الفلاح.
وقد رتب اللّه على التقوى من خير الدنيا والآخرة, شيئا كثيرا.
فذكر هنا, أن من اتقى اللّه, حصل له أربعة أشياء, كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها:
الأول: الفرقان, وهو: العلم والهدى, الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال, والحق والباطل,
والحلال والحرام, وأهل السعادة من أهل الشقاوة.
الثاني والثالث, تكفير السيئات, ومغفرة الذنوب.
وكل واحد منها داخل في الآخر, عند الإطلاق, وعند الاجتماع.
يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر, ومغفرة الذنوب, بتكفير الكبائر.
الرابع: الأجر العظيم, والثواب الجزيل, لمن اتقاه, وآثر رضاه على هوى نفسه.
” وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ” .
” وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين “
أي وأذكر, أيها الرسول, ما منَّ اللّه به عليك.
” وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ” حين تشاور المشركون في دار الندوة, فيما يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم,
إما أن يثبتوه عندهم بالحبس, ويوثقوه.
وإما أن يقتلوه فيستريحوا – بزعمهم – من دعوته.
وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم.
فكلُّ أبدى من هذه الآراء رأيا رآه.
فاتفق رأيهم, على رأي رآه شريرهم, أبو جهل, لعنه اللّه.
وهو أن يأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش, فتى, ويعطوه سيفا صارما, ويقتله الجميع قتلة رجل واحد,
ليتفرق دمه في القبائل.
فيرضى بنو هاشم ثَمَّ بديته, فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش.
فترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم, في الليل, ليوقعوا به, إذا قام من فراشه.
فجاء الوحي من السماء, وخرج عليهم, فذرَّ على رءوسهم التراب وخرج, وأعمى اللّه أبصارهم عنه.
حتى إذا استبطأوه, جاءهم آت وقال: خيبكم اللّه, قد خرج محمد, وذَرَّ على رءوسكم التراب.
فنفض كل منهم التراب عن رأسه.
ومنع اللّه رسوله منهم, وأذن له في الهجرة إلى المدينة.
فهاجر إليها, وأيده اللّه بأصحابه المهاجرين والأنصار.
ولم يزل أمره يعلو, حتى دخل مكة عنوة, وقهر أهلها.
فأذعنوا له, وصاروا تحت حكمه, بعد أن خرج مستخفيا منهم, خائفا على نفسه.
فسبحان اللطيف بعباده الذي لا يغالبه مغالب.
” وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين “
يقول تعالى – في بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم – ” وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ”
الدالة على صدق ما جاء به الرسول.
” قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ” وهذا من عنادهم وظلمهم.
وإلا فقد تحداهم اللّه, أن يأتوا بسورة من مثله, ويدعوا من استطاعوا من دون اللّه,
فلم يقدروا على ذلك, وتبين عجزهم.
فهذا القول الصادر من هذا القائل, مجرد دعوى, كذبه الواقع.
وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أُمِّيٌّ, لا يقرأ ولا يكتب, ولا رحل ليدرس, من أخبار الأولين,
فأتى بهذا الكتاب الجليل, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
” وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم “
” وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا ” الذي يدعو إليه محمد ” هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ” قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم, والجهل بما ينبغي من الخطاب.
فلو أنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات, ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه – قالوا لمن ناظرهم,
وادعى أن الحق معه.
إن كان هذا هو الحق من عندك, فاهدنا له, لكان أولى لهم وأستر لظلمهم.
فمنذ قالوا: ” اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ” الآية, علم بمجرد قولهم,
أنهم السفهاء الأغبياء, الجهلة الظالمون.
فلو عاجلهم اللّه بالعقاب, لما أبقى منهم باقية.
” وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون “
ولكنه تعالى, دفع عنهم العذاب, بسبب وجود الرسول بين أظهرهم فقال:
” وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ” فوجوده صلى الله عليه وسلم, أمنة لهم من العذاب.
وكانوا مع قولهم هذه المقالة, التي يظهرونها على رءوس الأشهاد,
يدرون بقبحها فكانوا يخافون من وقوعها فيهم, فيستغفرون اللّه تعالى فلهذا قال
” وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ” .
فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم, بعد ما انعقدت أسبابه.
” وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون “
ثم قال ” وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ” أي: أي شيء يمنعهم من عذاب اللّه,
وقد فعلوا ما يوجب ذلك وهو صد الناس عن المسجد الحرام, خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم,
وأصحابه, الذين هم أولى به منهم.
ولهذا قال: ” وَمَا كَانُوا ” أي المشركون ” أَوْلِيَاءَهُ ” يحتمل أن الضمير يعود إلى اللّه, أي: أولياء اللّه.
ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام, أي: وما كانوا أولى به من غيرهم.
” إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ” وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله, وأفردوا اللّه بالتوحيد والعبادة, وأخلصوا له الدين.
” وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ” فلذلك ادَّعَوْا لأنفسهم أمرا, غيرهم أولى به.
” وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون “
يعني: أن اللّه تعالى, إنما جعل بيته الحرام, ليقام فيه دينه, وتخلص له فيه العبادة.
فالمؤمنون, هم الذين قاموا بهذا الأمر.
وأما هؤلاء المشركون, الذين يصدون عنه, فما كان صلاتهم فيه, التي هي أكبر أنواع العبادات ” إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ” .
أي صفيرا وتصفيقا, فعل الجهلة الأغبياء, الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم, ولا معرفة بحقوقه, ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها.
فإذا كانت هذه صلاتهم فيه, فكيف ببقية العبادات؟!!.
فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين, الذين هم في صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغو معرضون, إلى آخر ما وصفهم اللّه به من الصفات الحميدة, والأفعال السديدة.
لا جرم, أورثهم اللّه بيته الحرام, ومكنهم منه.
وقال – يعد ما مكن لهم منه – ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ” .
وقال هنا ” فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ” .
” إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة
ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون “
يقول تعالى – مبينا لعداوة المشركين, وكيدهم, ومكرهم, ومبارزتهم للّه ولرسوله,
وسعيهم في إطفاء نوره, وإخماد كلمته, وأن وبال مكرهم سيعود عليهم, ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله,
فقال: ” إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ” أي: ليبطلوا الحق, وينصروا الباطل,
ويبطل توحيد الرحمن, ويقوم دين عبادة الأوثان.
” فَسَيُنْفِقُونَهَا ” أي: فسيصدرون هذه النفقة, وتخف عليهم, لتمسكهم بالباطل, وشدة بغضهم للحق.
” ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ” أي: ندامة, وخزيا, وذلا.
” ثُمَّ يُغْلَبُونَ ” فتذهب أموالهم, وما أملوا, ويعذبون في الآخرة أشد العذاب.
ولهذا قال: ” وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ” أي: يجمعون إليها, ليذوقوا عذابها, وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء.
” ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا
فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون “
واللّه تعال يريد أن يميز الخبيث من الطيب, ويجعل كل واحد على حدة, وفي دار تخصه.
فيجعل الخبيث بعضه على بعض, من الأعمال, والأموال والأشخاص.
” فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ” الذين خسروا أنفسهم,
وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران المبين.
” قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين “
هذا من لطفه تعالى بعباده, لا بمنعه كفر العباد, ولا استمرارهم في العناد,
من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى, وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى,
فقال: ” قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا ” عن كفرهم, وذلك بالإسلام للّه وحده لا شريك له.
” يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ” منهم من الجرائم ” وَإِنْ يَعُودُوا ” إلى كفرهم وعنادهم ” فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ” ب
إهلاك الأمم المكذبة, فلينتظروا ما حل بالمعاندين, فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
فهذا خطابه للمكذبين.
” وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير “
وأما خطابه للمؤمنين, عندما أمرهم بمعاملة الكافرين, فقال: ” وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ”
أي: شرك, وصد عن سبيل اللّه ويذعنوا لأحكام الإسلام.
” وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ” فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين, أن يدفع شرهم عن الدين,
وأن يذب عن دين اللّه, الذي خلق الخلق له, حتى يكون هو العالي على سائر الأديان.
” فَإِنِ انْتَهَوْا ” عن ما هم عليه من الظلم ” فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ” لا تخفى عليه منهم خافية.
” وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير “
” وَإِنْ تَوَلَّوْا ” عن الطاعة, وأوضعوا في الإضاعة ” فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى ” ا
لذي يتولى عباده المؤمنين, ويوصل إليهم مصالحهم, وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية.
” وَنِعْمَ النَّصِيرُ ” الذي ينصرهم, فيدفع عنهم كيد الفجار, وتكالب الأشرار.
ومن كان اللّه مولاه وناصره, فلا خوف عليه, ومن كان اللّه عليه, فلا عِزَّ له, ولا قائمة تقوم له.
” واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على كل شيء قدير “
يقول تعالى: ” وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ” أي: أخذتم من مال الكفار قهرا بحق, قليلا كان أو كثيرا.
” فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ” أي: وباقيه لكم, أيها الغانمون, لأنه أضاف الغنيمة إليهم, وأخرج منها خمسها.
فدل على أن الباقي لهم, يقسم على ما قسمه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
للراجل سهم, والفارس سهمان سهم لفرسه, وسهم له.
وأما هذا الخمس, فيقسم خمسة أسهم, سهم للّه ولرسوله, يصرف في مصالح المسلمين العامة,
من غير تعيين لمصلحة, لأن اللّه جعله له ولرسوله, واللّه ورسوله غنيان عنه, فعلم أنه لعباد اللّه.
فإذا لم يعين اللّه له مصرفا, دل على أن مصرفه للمصالح العامة.
والخمس الثاني: لذي القربى, وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم, من بني هاشم, وبني المطلب.
وأضافه اللّه إلى القرابة, دليلا على أن العلة فيه, مجرد القرابة, فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم, ذكرهم وأنثاهم.
والخمس الثالث, لليتامى وهم: الذين فقدت آباؤهم, وهم صغار, جعل اللّه لهم خمس الخمس,
رحمة بهم, حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم, وقد فقد من يقوم بمصالحهم.
والخمس الرابع للمساكين, أي: المحتاجين الفقراء, من صغار, وكبار, ذكور, وإناث والخمس الخامس,
لابن السبيل, وهو: الغريب المنقطع به في غير بلده.
وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة, لا يخرج عن هذه الأصناف, ولا يلزم أن يكونوا فيه,
على السواء, بل ذلك تبع للمصلحة, وهذا هو الأولى.
وجعل اللّه أداء الخمس على وجهه, شرطا للإيمان فقال: ” إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ”
وهو يوم ” بدر ” الذي فرق اللّه به بين الحق والباطل, وأظهر الحق: وأبطل الباطل.
” يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ” جمع المسلمين, وجمع الكافرين.
أي: إن كان إيمانكم باللّه, وبالحق الذي أنزله اللّه على رسوله يوم الفرقان, الذي حصل فيه من الآيات والبراهين,
ما دل على أن ما جاء به هو الحق.
” وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ” لا يغالب أحد إلا غلبه.
” إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد
ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم “
” إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا ” أي: بعدوة الوادي القريبة من المدينة.
” وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى ” أي: جانبه البعيد من المدينة, فقد جمعكم واد واحد.
” وَالرَّكْبُ ” الذي خرجتم لطلبه, وأراد اللّه غيره ” أَسْفَلَ مِنْكُمْ ” مما يلي ساحل البحر.
” وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ ” أنتم وإياهم على هذا الوصف, وبهذه الحال ” لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ”
أي: لا بد من تقدم أو تأخر, أو اختيار منزل, أو غير ذلك, مما يعرض لكم, أو لهم, يصدفكم عن ميعادهم.
” وَلَكِنْ ” اللّه جمعكم على هذه الحال ” لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ” أي: مقدرا في الأزل, لا بد من وقوعه.
” لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ” أي ليكون حجة وبينة للمعاند, فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه,
فلا يبقى له عذر عند اللّه.
” وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ” أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقينا, بما أرى اللّه الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه,
ما هو تذكرة لأولي الألباب.
” وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ ” سميع لجميع الأصوات, باختلاف اللغات, على تفنن الحاجات.
” عَلِيمٌ ” بالظواهر, والضمائر, والسرائر, والغيب, والشهادة.
” إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور “
وكان اللّه قد أرى رسوله, المشركين في الرؤيا, قليلا, فبشر بذلك أصحابه, فاطمأنت قلوبهم, وتثبتت أفئدتهم.
” وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا ” فأخبرت بذلك أصحابك ” لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ” .
فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم, ومنكم من لا يرى ذلك, والتنازع مما يوجب الفشل.
” وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ” أي: لطف بكم ” إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ” أي: بما فيها من ثبات وجزع, وصدق وكذب.
” وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور “
فعلم اللّه من قلوبكم, ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم, وصدق رؤيا رسوله.
فأرى اللّه المؤمنين عدوهم, قليلا في أعينهم, ويقللكم – يا معشر المؤمنين – في أعينهم.
فكل من الطائفتين, ترى الأخرى قليلة, لتقدم كل منهما على الأخرى.
” لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ” من نصر المؤمنين, وخذلان الكافرين وقتل قادتهم,
ورؤساء الضلال منهم, ولم يبق منهم أحد, له اسم يذكر, فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام,
فصار أيضا لطفا بالباقين, الذين مَنَّ اللّه عليهم بالإسلام.
” وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ” أي: جميع أمور الخلائق ترجع إلى اللّه, فيميز الخبيث من الطيب,
ويحكم في الخلائق بحكمه العادل, الذي لا جور فيه, ولا ظلم.
” يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون “
يقول تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ” أي: طائفة من الكفار تقاتلكم.
” فَاثْبُتُوا ” لقتالها, واستعملوا الصبر, وحبس النفس, على هذه الطاعة الكبيرة, التي عاقبتها العز والنصر.
واستعينوا على ذلك, بالإكثار من ذكر اللّه ” لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ” أي: تدركون ما تطلبون, من الانتصار على أعدائكم.
فالصبر والثبات, والإكثار من ذكر اللّه, من أكبر الأسباب للنصر.
” وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين “
” وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ” في استعمال ما أمروا به, والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال.
” وَلَا تَنَازَعُوا ” تنازعا يوجب تشتيت القلوب وتفرقها.
” فَتَفْشَلُوا ” أي: تجبنوا ” وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ” أي: وتنحل عزائمكم, وتفرق قوتكم,
ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة اللّه ورسوله.
” وَاصْبِرُوا ” نفوسكم على طاعة اللّه ” إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ” بالعون والنصر والتأييد, واخشعوا لربكم, واخضعوا له.
” ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط “
” وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ”
أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه, وهذا الذي أبرزهم من ديارهم, لقصد الأشر والبطر في الأرض, وليراهم الناس ويفخروا لديهم.
والمقصود الأعظم: أنهم خرجوا, ليصدوا عن سبيل اللّه, من أراد سلوكه.
” وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ” فلذلك أخبركم بمقاصدهم, وحذركم أن تشبهوا بهم,
فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة.
فليكن قصدكم في خروجكم, وجه اللّه تعالى, وإعلاء دين اللّه, والصد عن الطريق الموصلة إلى سخط اللّه وعقابه,
وجذب الناس إلى سبيل اللّه القويم, الموصل لجنات النعيم.
” وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس
وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم
إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب “
” وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ” حسنها في قلوبهم.
” وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ” , فإنكم في عَدَدٍ وعُدَدٍ, وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه.
” وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ” من أن يأتيكم أحد, ممن تخشون غائلته,
لأن إبليس قد تبدَّى لقريش في سورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وكانوا يخافون من بني مدلج,
لعداوة كانت بينهم.
فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم, فاطمأنت نفوسهم, وأتوا على حرد قادرين.
فلما ” تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ ” المسلمون والكافرون, فرأى الشيطان جبريل عليه السلام
يزع الملائكة خاف خوفا شديدا و ” نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ” أي: ولى مدبرا.
” وَقَالَ ” لمن خدعهم وغرهم: ” إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ” .
أي: أرى الملائكة الذين لا يدان, لأحد بقتالهم.
” إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ” أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا ” وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ” .
ومن المحتمل أن يكون الشيطان, سول لهم, ووسوس في صدورهم, أنه لا غالب لهم اليوم من الناس, وأنه جار لهم.
فلما أوردهم مواردهم, نكص عنهم, وتبرأ منهم, كما قال تعالى: ” كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ” .
” إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم “
” إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ” أي: شك وشبهة, من ضعفاء الإيمان, للمؤمنين,
حين أقدموا – مع قلتهم – على قتال المشركين مع كثرتهم.
” غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ” أي: أوردهم الدين الذي هم عليه, هذه الموارد, التي لا يدان لهم بها, ولا استطاعة لهم بها.
يقولونه, احتقارا لهم, واستخفافا بعقولهم, وهم – واللّه – الأخِفَّاءُ عقولا, الضعفاء أحلاما.
فإن الإيمان, يوجب لصاحبه, الإقدام على الأمور الهائلة, التي لا يقدم عليها الجيوش العظام.
فإن المؤمن المتوكل على اللّه, الذي يعلم أنه, ما من حول, ولا قوة, ولا استطاعة لأحد, إلا باللّه تعالى.
وأن الخلق, لو اجتمعوا كلهم, على نفع شخص, بمثقال ذرة, لم ينفعوه.
ولو اجتمعوا على أن يضروه, لم يضروه إلا بشيء قد كتبه اللّه عليه, وعلم أنه على الحق,
وأن اللّه تعالى حكيم رحيم, في كل ما قدره وقضاه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه, من قوة وكثرة,
وكان واثقا بربه, مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا.
ولهذا قال: ” وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ” لا تغالب قوته قوة.
” حَكِيمٌ ” فيما قضاه وأجراه.
” ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق “
يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات اللّه, حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم,
وقد اشتد بهم القلق, وعظم كربهم, و ” الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ” يقولون لهم:
أخرجوا أنفسكم, ونفوسهم ممتنعة مستعصية على الخروج, لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم.
ولهذا قال: ” وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ” أي: العذاب الشديد المحرق.
” ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد “
ذلك العذاب, حصل لكم غير ظلم ولا جور, من ربكم, وإنما هو بما قدمت أيديكم,
من المعاصي, التي أثرت لكم ما أثرت, وهذه سنة اللّه في الأولين والآخرين.
فإن دأب هؤلاء المكذبين أي: سنتهم, وما أجرى اللّه عليهم من الهلاك, بذنوبهم.
” كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب “
” كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ” من الأمم المكذبة.
” كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ” بالعقاب ” بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ” لا يعجزه أحد يريد أخذه,
” مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ” .
” ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم “
” ذَلِكَ ” العذاب الذي أوقعه اللّه بالأمم المكذبة, وأزال عنهم ما هم فيه, من النعم والنعيم,
بسبب ذنوبهم, وتغييرهم ما بأنفسهم.
” بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ ” من نعم الدين والدنيا, بل يبقيها,
ويزيدهم منها, إن ازدادوا له شكرا.
” حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ” من الطاعة إلى المعصية, فيكفروا نعمة اللّه, ويبدلوا بها كفرا,
فيسلبهم إياها, ويغيرها عليهم, كما غيروا ما بأنفسهم.
وللّه الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده, حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم,
وحيث جذب قلوب أوليائه إليه, بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره.
” وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ” يسمع جميع ما نطق به الناطقون, سواء من أسر القول ومن جهر به.
ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر, وتخفيه السرائر, فيجري على عباده من الأقدار, ما اقتضاه علمه, وجرت به مشيئته.
” كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين “
” كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ” أي: فرعون وقومه ” وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ” حين جاءتهم
” فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ” كل بحسب جرمه.
” وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ ” من المهلكين المعذبين ” كَانُوا ظَالِمِينَ ” لأنفسهم,
ساعين في هلاكها, لم يظلمهم اللّه, ولا أخذهم بغير جرم اقترفوه.
فليحذر المخاطبون, أن يشابهوهم في الظلم, فيحل اللّه بهم من عقابه, ما أحل بأولئك الفاسقين.
” إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون “
” إِنَّ ” هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث – الكفر, وعدم الإيمان, والخيانة – بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه,
ولا قول قالوه.
هم ” شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ” فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها,
لأن الخير معدوم منهم, والشر متوقع فيهم.
” فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون “
فإذهاب هؤلاء ومحقهم, هو المتعين, لئلا يسري داؤهم لغيرهم ولهذا قال:
” فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ ” أي: تجدنهم في حال المحاربة, بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق.
” فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ” أي نكل بهم غيرهم, وأوقع بهم من العقوبة, ما يصيرون به,
عبرة لمن بعدهم ” لَعَلَّهُمْ ” أي: من خلفهم ” يَذْكُرُونَ ” صنيعهم, لئلا يصيبهم ما أصابهم.
وهذه من فوائد العقوبات والحدود, المرتبة على المعاصي, أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي,
بل وزجرا لمن عملها, أن لا يعاودها.
ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب, أن الكافر – ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر –
أنه إذا أُعْطِيَ عهدا, لا يجوز خيانته وعقوبته.
” وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين “
أي: وإذا كان بينك وبين قوم, عهد وميثاق, على ترك القتال, فخفت منهم خيانة.
بأن ظهر من قرائن أحوالهم, ما يدل على خيانتهم, من غير تصريح منهم بالخيانة.
” فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ ” عهدهم, أي: ارمه عليهم, وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم.
” عَلَى سَوَاءٍ ” أي: حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك, ولا يحل لك أن تغدرهم,
أو تسعى في شيء مما منعه, موجب العهد, حتى تخبرهم بذلك.
” إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ” بل يبغضهم أشد البغض.
فلا بد من أمر بيِّنٍ, يبرئكم من الخيانة.
ودلت الآية, على أنه, إذا وجدت الخيانة المحققة منهم, لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم,
لأنه لم يخف منهم, بل علم ذلك, ولعدم الفائدة ولقوله: ” عَلَى سَوَاءٍ ” .
وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم.
ودل مفهومها أيضا, أنه إذا لم يُخَفْ منهم خيانة, بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك,
أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم, بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته.
” ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون “
أي: لا يحسب الكافرون بربهم, المكذبون بآياته, أنهم سبقوا اللّه وفاتوه, فإنهم لا يعجزونه, واللّه لهم بالمرصاد.
وله تعالى الحكمة البالغة, في إمهالهم, وعدم معاجلتهم بالعقوبة, التي من جملتها, ابتلاء عباده المؤمنين, وامتحانهم, وتزودهم من طاعته ومراضيه, ما يصلون به المنازل العالية, واتصافهم بأخلاق وصفات, لم يكونوا بغيره, بالغيها.
فلهذا قال لعباده المؤمنين: ” وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ” إلى ” وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ” .
” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون “
أي: ” وَأَعِدُّوا ” لأعدائكم الكفار, الساعين في هلاككم, وإبطال دينكم.
” مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ” أي: كل ما تقدرون عليه, من القوة العقلية والبدنية;
وأنواع الأسلحة ونحو ذلك, مما يعين على قتالهم.
فدخل في ذلك, أنواع الصناعات, التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات, من المدافع,
والرشاشات, والبنادق, والطيارات الجوية, والمراكب البرية والبحرية, والقلاع, والخنادق,
وآلات الدفاع, والرأْي والسياسة, التي بها يتقدم المسلمون, ويندفع عنهم به, شر أعدائهم,
وتَعَلُّم الرَّمْيِ, والشجاعة, والتدبير.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ” ألا إن القوة الرَّمْيُ ” .
ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال.
ولهذا قال تعالى: ” وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ” .
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان, وهي إرهاب الأعداء, والحكم يدور مع علته.
فإذا كان شيء موجودا أكثر إرهابا منها, كالسيارات البرية والهوائية, المعدة للقتال, التي تكون النكاية فيها أشد, كانت مأمورا بالاستعداد بها, والسعي لتحصيلها.
حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلُّم الصناعة, وجب ذلك, لأن ” ما لا يتم الواجب إلا به, فهو واجب ” .
وقوله ” تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ” ممن تعلمون أنهم أعداؤكم.
” وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ” ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت, الذي يخاطبهم الله به ” اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ” فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم.
ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك, النفقات المالية, في جهاد الكفار.
ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: ” وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ” قليلا كان أو كثيرا ” يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ” أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة.
حتى إن النفقة في سبيل اللّه, تضاعف إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة.
” وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ” أي: لا تنقصون, من أجرها وثوابها, شيئا.
” وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم “
يقول تعالى ” وَإِنْ جَنَحُوا ” أي: الكفار المحاربون أي: مالوا ” لِلسَّلْمِ ” أي: الصلح وترك القتال.
” فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ” أي: أجبهم إلى ما طلبوا, متوكلا على ربك, فإن في ذلك فوائد كثيرة.
منها: أن طلب العافية, مطلوب كل وقت, فإذا كانوا, هم المبتدئين في ذلك, كان أولى لإجابتهم.
ومنها: أن في ذلك استجماما لقواكم, واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر, إن احتيج إلى ذلك.
ومنها: أنكم, إذا أصلحتم, وأمن بعضكم بعضا, وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر, فإن الإسلام يعلو, ولا يعلى عليه.
فكل من له عقل وبصيرة, إذا كان معه إنصاف, فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان, لحسنه في أوامره ونواهيه, وحسنه في معاملته للخلق, والعدل فيهم, وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه, فحينئذ يكثر الراغبون فيه, والمتبعون له.
فصار هذا السلم, عونا للمسلمين على الكافرين.
ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة, وهي أن يكون الكفار, قصدهم بذلك, خدع المسلمين, وانتهاز الفرصة فيهم.
” وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين “
فأخبرهم اللّه, أنه حسبهم وكافيهم خداعهم, وأن ذلك يعود عليهم ضرره فقال:
” وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ” أي: كافيك ما يؤذيك, وهو القائم بمصالحك ومهماتك,
فقد سبق لك من كفايته لك ونصره, ما يطمئن به قلبك.
وإنه ” هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ” أي: أعانك بمعونة سماوية وهو: النصر منه,
الذي لا يقاومه شيء, ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك.
” وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم “
” وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ” فاجتمعوا وائتلفوا, وازدادت قوتهم, بسبب اجتماعهم.
ولم يكن هذا بسعي أحد, ولا بقوة, غير قوة اللّه.
وإنك ” لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ” من ذهب, وفضة وغيرهما, لتأليفهم بعد تلك النفرة,
والفرقة الشديدة ” مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ” لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا اللّه تعالى.
” وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ” ومن عزته, أن ألف بين قلوبهم, وجمعها بعد الفرقة كما قال تعالى:
” وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ” .
” يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين “
ثم قال تعالى ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ” أي: كافيك ” وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ” أي: وكافي أتباعك من المؤمنين.
وهذا وعد من اللّه, لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله, بالكفاية, والنصرة على الأعداء.
فإذا أتوا بالسبب, الذي هو الإيمان والاتباع, فلابد أن يكفيهم ما أهمهم, من أمور الدين والدنيا,
وإنما تتخلف الكفاية, بتخلف شرطها.
” يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون “
يقول تعالى, لنبيه صلى الله عليه وسلم: ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ” أ
ي: حثهم واستنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم, وينشط هممهم, من الترغيب في الجهاد,
ومقارعة الأعداء, والترهيب من ضد ذلك, وذكر فضائل الشجاعة, والصبر, وما يترتب على ذلك,
من خير في الدنيا والآخرة, وذكر مضار الجبن, وأنه من الأخلاق الرذيلة, المنقصة للدين والمروءة,
وأن الشجاعة بالمؤمنين, أولى من غيرهم ” إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ” .
” إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ” أيها المؤمنون ” عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ”
يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار.
وذلك ” بِأَنَّهُمْ ” أي: الكفار ” قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ” أي: لا علم عندهم, بما أعد اللّه للمجاهدين في سبيله,
فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض, والفساد فيها.
وأنتم تفقهون المقصود من القتال, أنه لإعلاء كلمة اللّه, وإظهار دينه والذب عن كتاب اللّه,
وحصول الفوز الأكبر عند اللّه.
وهذه كلها, دواع للشجاعة والصبر, والإقدام على القتال.
” الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين “
ثم إن هذا الحكم خففه اللّه على العباد فقال: ” الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ”
فلذلك اقتضت رحمته وحكمته, التخفيف.
” فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ” بعونه وتأييده.
وهذه الآيات, صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين, بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين,
يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار, وأن اللّه يمتن عليهم, بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية.
ولكن معناها وحقيتها, الأمر, وأن اللّه أمر المؤمنين – في أول الأمر – أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة,
والعشرة من المائة, والمائة من الألف.
ثم إن اللّه خفف ذلك, فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار, فإن زادوا على مثليهم,
جاز لهم الفرار, ولكن يرد على هذا أمران.
أحدهما: أنها بصورة الخبر, والأصل في الخبر, أن يكون على بابه, وأن المقصود بذلك, الامتنان, والإخبار بالواقع.
والثاني: تقييد ذلك العدد, أن يكونوا صابرين, بأن يكونوا متدربين على الصبر.
ومفهوم هذا, أنهم إذا لم يكونوا صابرين, فإنه يجوز لهم الفرار, ولو أقل من مثلهم,
إذا غلب على ظنهم الضرر, كما تقتضيه الحكمة الإلهية.
ويجاب عن الأول, بأن قوله: ” الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ” إلى آخرها, دليل على أن هذا الأمر لازم,
وأمر محتم, ثم إن اللّه خففه إلى ذلك العدد.
فهذا ظاهر في أنه أمر, وإن كان في صيغة الخبر.
وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر, نكتة بديعة, لا توجد فيه, إذا كان بلفظ الأمر.
وهي: تقوية قلوب المؤمنين, والبشارة بأنهم, سيغلبون الكافرين.
ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين, أنه حث على الصبر,
وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك.
فإذا فعلوها, صارت الأسباب الإيمانية, والأسباب المادية, مبشرة بحصول ما أخبر اللّه به,
من النصر, لهذا العدد القليل
” ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم “
هذه معاتبة من اللّه لرسوله وللمؤمنين, يوم ” بدر ” إذ أسروا المشركين, وأبقوهم لأجل الفداء.
وكان رَأْيُ أمير المؤمنين, عمر بن الخطاب في هذه الحال, قتلهم واستئصالهم.
فقال تعالى: ” مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ”
أي: ما ينبغي, ولا يليق به, إذا قاتل الكفار, الذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه, ويسعون لإخماد دينه,
وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد اللّه, أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم, لأجل الفداء,
الذي يحصل منهم, وهو عرض قليل, بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم, وإبطال شرهم.
فما دام لهم شر وصولة, فالأوفق أن لا يؤسروا.
فإذا أثخن في الأرض, وبطل شر المشركين, واضمحل أمرهم, فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم, وإبقائهم.
يقول تعالى: ” تُرِيدُونَ ” بأخذكم الفداء وإبقائهم ” عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ” أي: لا لمصلحة تعود إلى دينكم.
” وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ” بإعزاز دينه, ونصر أوليائه, وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم, فيأمركم بما يوصل إلى ذلك.
” وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ” أي: كامل العزة, ولو شاء أن ينتصر من الكفار, من دون قتال, لفعل ولكنه حكيم, يبتلي بعضكم ببعض.
” لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم “
” لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ” به القضاء والقدر, أنه قد أحل لكم الغنائم,
وأن اللّه رفع عنكم – أيتها الأمة – العذاب ” لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ”
وفي الحديث ” لو نزل عذاب يوم بدر, ما نجا منه إلا عمر ” .
” فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم “
” فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ” وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة, أن أحل لها الغنائم, ولم تحل لأمة قبلها.
” وَاتَّقُوا اللَّهَ ” في جميع أموركم ولازموها, شكرا لنعم اللّه عليكم.
” إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ” يغفر لمن تاب إليه, جميع الذنوب.
ويغفر لمن لم يشرك به شيئا, جميع المعاصي.
” رَحِيمٌ ” بكم, حيث أباح لكم الغنائم, وجعلها حلالا طيبا.
” يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا
يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم “
وهذه نزلت في أسارى يوم بدر, وكان من جملتهم, العباس, عم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
فلما طلب منه الفداء, ادَّعى أنه مسلم قبل ذلك, فلم يسقطوا عنه الفداء.
فأنزل اللّه تعالى, جبرا لخاطره, ومن كان على مثل حاله.
” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ”
أي: من المال, بأن ييسر لكم من فضله, خيرا كثيرا, مما أخذ منكم.
” وَيَغْفِرْ لَكُمْ ” ذنوبكم, ويدخلكم الجنة ” وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ” .
وقد أنجز اللّه وعده للعباس وغيره, فحصل له – بعد ذلك – من المال, شيء كثير.
حتى إنه مرة, لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم, مال كثير, أتاه العباس,
فأمره أن يأخذ منه بثوبه, ما يطيق حمله فأخذ منه, ما كاد أن يعجز عن حمله.
” وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم “
” وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ” في السعي لحربك, ومنابذتك.
” فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ” فليحذروا خيانتك, فإنه تعالى قادر عليهم, وهم تحت قبضته.
واللّه عليم حكيم أي: عليم بكل شيء, حكيم, يضع الأشياء مواضعها.
ومن علمه وحكمته, أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة, وقد تكفل بكفايتكم, شأن الأسرى وشرهم, إن أرادوا خيانة.
” إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير “
هذا عقد موالاة ومحبة, عقدها اللّه بين المهاجرين, الذين آمنوا وهاجروا في سبيل اللّه.
وتركوا أوطانهم للّه, لأجل الجهاد في سبيل اللّه.
وبين الأنصار, الذين آووا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم, وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم.
فهؤلاء, بعضهم, أولياء بعض, لكمال إيمانهم, وتمام اتصال بعضهم ببعض.
” وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ” .
فإنهم قطعوا ولايتكم, بانفصالهم عنكم, في وقت شدة الحاجة إلى الرجال.
فلما لم يهاجروا, لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء.
لكنهم ” وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ ” أي: لأجل قتال من قاتلهم ” فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ” والقتال معهم.
وأما من قاتلوهم لغير ذلك, من المقاصد, فليس عليكم نصرهم.
وقوله تعالى ” إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ” أي: عهد بترك القتال, فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون, الذين لم يهاجروا قتالهم, فلا تعينوهم عليهم, لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق.
” وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ” يعلم ما أنتم عليه, من الأحوال, فيشرع لكم من الأحكام, ما يليق بكم.
” والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير “
لما عقد الولاية بين المؤمنين, أخبر أن الكفار, حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض, فلا يواليهم إلا كافر مثلهم.
وقوله ” إِلَّا تَفْعَلُوهُ ” أي: موالاة المؤمنين, ومعاداة الكافرين, بأن واليتموهم أو عاديتموهم كلهم, أو واليتم الكافرين, وعاديتم المؤمنين ” تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ” فإنه يحصل بذلك, من الشر, ما لا ينحصر, من اختلاط الحق بالباطل, والمؤمن بالكافر, وعدم كثير من العبادات الكبار, كالجهاد, والهجرة, وغير ذلك من مقاصد الشرع, والدين, التي تفوت, إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء, بعضهم لبعض.
” والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم “
الآيات السابقات, في ذكر عقد الموالاة, بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار.
وهذه الآيات, في بيان مدحهم وثوابهم, فقال: ” وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ” من المهاجرين والأنصار أي: المؤمنون ” حَقًّا ” لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به, من الهجرة, والنصرة, والموالاة, بعضهم لبعض, وجهادهم لأعدائهم, من الكفار والمنافقين.
” لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ” من اللّه, تمحى بها سيئاتهم, وتضمحل بها زلاتهم.
ولهم ” وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ” أي: خير كثير, من الرب الكريم, في جنات النعيم.
وربما حصل لهم من الثواب المعجل, ما تقر به أعينهم, وتطمئن به قلوبهم.
” والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم “
وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار, ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل اللّه.
” فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ” لهم ما لكم وعليهم ما عليكم.
فهذه الموالاة الإيمانية – وقد كانت في أول الإسلام – لها وقع كبير, وشأن عظيم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم, آخى بين المهاجرين والأنصار.
أخوة خاصة, غير الأخوة الإيمانية العامة, وحتى كانوا يتوارثون بها, فأنزل اللّه ” وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ” .
فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات, وأصحاب الفروض.
فإن لم يكونوا, فأقرب قراباته, من ذوي الأرحام, كما دل عليه عموم الآية الكريمة.
وقوله ” فِي كِتَابِ اللَّهِ ” أي: في حكمه وشرعه.
” إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ” ومنه ما يعلمه, من أحوالكم, التي يجري من شرائعه الدينية عليكم, ما يناسبها.