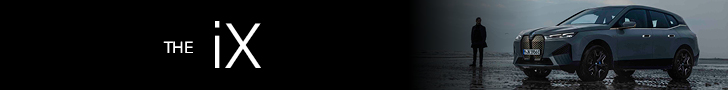بمشروع وطني.. السعودية تُعيد تشكيل جمال الخط العربي

الباحث في الخط العربي، الخطاط رضوان الحسيني:
إطلاق “الخط الأول” و”الخط السعودي” خطوة مدروسة ومحورية في مسار إحياء الهوية البصرية العربية، وربطها بالمعاصرة بطريقة لا تُفرط في روح التراث.
خطوة مهمة جداً خطتها السعودية بإعلان إطلاق “الخط الأول” و”الخط السعودي”، ضمن مشروع وطني يهدف إلى إحياء روح الخط العربي الأصيلة، وربطها بمفاهيم التصميم المعاصر، ما يدلّ على اهتمام متنامٍ بالهوية الثقافية وتجلياتها البصرية.
يعكس هذان الخطان، من حيث الشكل والمضمون، الروح الجمالية والتاريخية للخطوط العربية، التي كانت منطقة الجزيرة العربية موطناً أصيلاً لها عبر العصور، وهو ما يدفع السعودية لترسيخ مكانتها بصفتها حاضنة تاريخية للخط العربي ومهد للثقافة العربية.
بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن إطلاق الخطين يمثل “جسراً يصل بين الماضي والحاضر”، إذ يُدمجان بين جماليات الخط العربي التقليدي، وبين أساليب التصميم الحديثة.
واعتبر وزير الثقافة أن هذه المبادرة تكرّم الإرث الفني العريق للمملكة، وتُجسّد رؤيتها الثقافية في ظل ما تشهده من نهضة حضارية.
يستمد “الخط الأول” روحه من النقوش الحجرية التي تعود إلى القرن الأول الهجري، والتي زخرت بها الجزيرة العربية.
يتميّز هذا الخط بوضوحه الجمالي ودقّة تفاصيله المستوحاة من الطابع اليابس، مع محاكاة دقيقة لأشكال الحروف كما ظهرت في النقوش القديمة.
أما “الخط السعودي”، فجاء ليُترجم الهوية البصرية للمملكة بشكل معاصر، مرتكزاً على القواعد الفنية التي بُني عليها “الخط الأول”، مع تطويرها لتتناسب مع الاستخدامات الرقمية الحديثة والتطبيقات البصرية، في انعكاس مباشر لنهضة المملكة في مجالات الثقافة والفنون.
شارك في تطوير الخطين نخبة من الباحثين والمصممين المحليين والدوليين، ضمن منهجية علمية متكاملة، مرت بخمس مراحل شملت: البحث والتحليل الميداني، ودراسة النصوص والنقوش، وتصميم النماذج الأولية، ثم رسم الخط وتحديد قواعده الفنية والجمالية، وصولاً إلى الرقمنة والتطبيق العملي.
نشأة الخط العربي
بإطلاق “الخط الأول” و”الخط السعودي”، تُعيد المملكة التأكيد على دورها المركزي في حماية التراث العربي، وتقديمه برؤية معاصرة تنسجم مع روح العصر، دون أن تفقد جذورها الممتدة في عمق التاريخ.
تاريخياً، نشأ الخط العربي في شبه الجزيرة العربية، وخاصة في شمالها، حيث تطوّرت أشكال أولية من الحروف العربية عن الخطوط الأنباطية (النبطية)، التي كانت منتشرة في منطقة الحجر (مدائن صالح) والبتراء ودومة الجندل، خلال القرون الأولى قبل الميلاد.
وظهرت أنماط أولية من الكتابة العربية في مكة والمدينة والطائف قبل الإسلام، عُرفت بـ”الخط الحجازي”، وهي كتابة غير منتظمة لكنها كانت تُستخدم لتدوين الشعر والأمثال.
الخطوط الستة المعتمدة
على مرّ العصور التي تلت ظهور الإسلام، أخذت الخطوط العربية بالتطور وتأخذ أشكالاً جمالية مختلفة، ومع انتشار رقعة الإسلام تشكلت العديد من الخطوط وتفرعت من الخطوط الأساسية وبتسميات مختلفة.
لكن الخطوط الرئيسية التي ما زالت معتمدة هي ستة خطوط وتشمل حسب التسلسل الزمني:
الخط الكوفي
-
ظهر في مدينة الكوفة بالعراق في القرن السابع الميلادي (الأول الهجري)، وهو أقدم الخطوط العربية.
-
يتّسم بزواياه الحادة، وخطوطه المستقيمة، وبنائه الهندسي المتوازن.
-
استخدم في كتابة المصاحف والعمارة الإسلامية (خاصة الزخارف الحجرية).
خط النسخ
-
تبلور في العصر العباسي.
-
يتميز بالوضوح وسهولة القراءة، وتناسق الحروف واتساعها، وهو أكثر الخطوط استخداماً في الطباعة.
-
يُستخدم اليوم في المصاحف، الكتب، والصحف.
خط الثلث
-
ظهر في العصر العباسي وبلغ ذروته في العصر العثماني.
-
خط انسيابي ومعقد، يمتاز بطول الحروف وتداخلها، وبقدرة عالية على التشكيل والتزيين.
-
يُستخدم في تيجان الآيات، والعمارة، واللوحات الفنية.
خط التعليق (الفارسي)
-
نشأ في بلاد فارس بالقرن الرابع عشر.
-
رشيق وانسيابي، يمتاز بحروفه الطويلة والمائلة.
-
شاع في كتابة الشعر، واللوحات الجمالية.
الخط الديواني
-
نشأ في البلاط العثماني خلال القرن السادس عشر.
-
يتميّز بالمرونة والانسيابية، وتداخل الحروف بشكل متناسق.
-
خط رسمي وشديد الخصوصية، استخدم لتوثيق الفرمانات والقرارات السلطانية، واليوم يُستعمل في التصاميم والهوية البصرية الفاخرة.
خط الرقعة
-
تطوّر في أواخر العهد العثماني، وتُنسب صيغته الحديثة إلى الخطاط “ممتاز بك”.
-
بسيط وسريع في الكتابة، بحروف قصيرة ومستقيمة نسبياً، دون تشكيل معقد.
-
يُستخدم في الكتابات اليومية، والمراسلات الرسمية.
نموذج يحتذى به
يقول الباحث في الخط العربي، الخطاط رضوان الحسيني، في حديث لـ”الخليج أونلاين”، إن إطلاق السعودية لـ”الخط الأول” و”الخط السعودي” لا يمكن وصفه إلا بأنه خطوة مدروسة ومحورية في مسار إحياء الهوية البصرية العربية، وربطها بالمعاصرة بطريقة لا تُفرط في روح التراث.
يرى الحسيني أن هذين الخطين “لم يأتيا من فراغ؛ هناك عمق بحثي واضح في استلهام النقوش القديمة، خاصة في الخط الأول الذي يعود بجذوره إلى القرن الأول الهجري، وهي فترة تكاد تكون حجر الأساس في تشكل الشخصية البصرية للكتابة العربية”.
وعن أبرز التحديات التي تواجه تصميم خطوط عربية حديثة، يلفت الحسيني إلى أن “أكبر تحدٍ هو الموازنة بين الحفاظ على القواعد الجمالية والتقنية للخط التقليدي، ومتطلبات الاستخدام الحديث”.
ويضيف شارحاً طبيعة الحرف العربي بأنه “متصل ومتنوع وتزدهر فيه التفاصيل الدقيقة، وهذه خصائص يصعب ترجمتها برمجياً في بيئة رقمية تتحرك بمعايير جامدة أحياناً”.
ويتابع: “المشكلة ليست فقط في الشكل، بل في الحركات والتراكيب واتساق الوزن البصري للحروف؛ لذلك فعملية التصميم تتطلب تعاوناً بين الخطاط والمبرمج والمصمم الغرافيكي؛ وهو ما يبدو أن فريق العمل في الخطين السعودي والأول قد نجح فيه”.
وحول ما إذا كان الخطان يمثلان نموذجاً يُحتذى به، يجيب الحسيني “بكل تأكيد. ليس لأنهما الأجمل، فلكل خط هويته، بل لأن المنهجية التي صُمّما بها تقدم درساً مهماً مفاده أن علينا أن نبدأ من تراثنا، لا أن ننسخه. وأن نطوّعه بلغة العصر، لا أن نفرغه من مضمونه؛ وهذا ما فعله المشروع السعودي بدقة ووعي”.